«لنُخرِجَنَّكم من أرضِنا» … حين يتكلّم الطغيان بلغة السياسة… قراءة قرآنية في الإقصاء والتمكين
المهندسة: هاوين أنور عبد الله – بنت أربيل
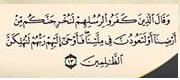
﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾
﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾
سورة إبراهيم: ١٣–١٤
ليست هذه الآيات مشهدًا تاريخيًا منقضيًا، بل نصًّا سياسيًا حيًّا، يتكرّر صداه كلّما نطق الطغيان بلغة السلطة، وكلّما توهّم المتغلّبون أن الأرض صكّ ملكية مسجّل بأسمائهم.
حين قال الذين كفروا لرسلهم: «لنُخرِجَنَّكم من أرضِنا»، كانوا يؤسّسون لمنطق سياسي مألوف في كل العصور، قوامه: احتكار الأرض، واحتكار الهوية، واحتكار الحقّ في الوجود. لم يكن التهديد أمنيًا فحسب، بل إعلانًا سياديًا متعاليًا، يجعل من الحاكم مصدر الشرعية الوحيد، ومن المخالف عنصرًا زائدًا عن الحاجة، قابلًا للإقصاء أو الإلغاء أو حتى الإفناء.
ثم يأتي الشقّ الثاني من التهديد: «أو لتعودنّ في ملّتنا».
وهنا يتعرّى جوهر الطغيان؛
فليست المسألة حدودًا ولا سيادة فحسب، بل إخضاعًا فكريًا وعقديًا، وفرضًا قسريًا لنمط الانتماء. إنها سياسة صهر الهويات، حيث يُسمح للمرء بالبقاء على الأرض فقط بجسده، دون وعيه أو معتقده أو كرامته، وشريطة التخلّي عن ذاته، والتماهي مع “الملّة” التي يرسمها السلطان الطاغية.
هذا المنطق لم يغب عن عالمنا المعاصر، فما أكثر الأنظمة التي تلوّح اليوم بلغة “الوطن” و“القانون” و“الأمن القومي” و“محاربة الإرهاب” لتبرير الإقصاء، وإسقاط الشرعية عن المخالفين، وتجريدهم من حقّهم في الانتماء، وكأن الأرض لا تتّسع إلا لصوت واحد، هو صوتهم النشاز، ورؤية واحدة هي رؤيتهم العقيمة، وملّة سياسية واحدة متغطرسة، ضالة ومضلة.
غير أن القرآن لا يترك هذا الادّعاء قائمًا، إذ يأتي الردّ الإلهي قاطعًا:
﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾.
إنه تفكيك مباشر لوهم السلطة المطلقة والكبرياء الكاذب؛ فالذين يهدّدون بالإخراج، هم الذين يُخرَجون من معادلة التاريخ، والذين يتوعّدون بالإلغاء، هم الذين يُلغَون بعد أن تستنفد أدوات قهرهم صلاحيتها.
ثم يأتي التحوّل الأخطر سياسيًا مبرماً في قوله تعالى: ﴿وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾.
لم يقل: أرضهم، ولا أرضكم. فالأرض في المنظور القرآني ليست وطنًا خاصًا بالطغاة، ولا غنيمة بيد المتغلّبين، بل ملكٌ لله وحده، يداولها بين عباده وفق سنن لا تخضع لخطابات السلطة، ولا لخرائط القوّة.
واللافت أن الوعد الإلهي جاء بصيغة السُّكنى لا التملّك؛ فهناك فرقٌ جوهري بين من يسكن الأرض بأمانة ويؤدّي مقتضيات جوهر الاستخلاف، وبين من يتملّكها بتعجرف واعتدادٍ بالنفس.
السكنى تعني المسؤولية، والعدل، وصون حقوق الرعية، والقيام بأمانة الاستخلاف غايةً وتوجّهًا.
أما التملّك المتغطرس، فيفضي إلى التألّه والاستعلاء، والتمادي في الإقصاء، واستخدام أقصى أدوات الاستبداد، أي تحويل الأرض إلى أداة لفرض السيطرة، لا فضاءً للعيش المشترك، ولا ميدانًا للعدل، ولا موضعًا لإعمار النفس والأرض.
لكنّ القرآن لا يمنح هذا التمكين على بياض، بل يختم الوعد بشرطٍ حاسم:
﴿ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾.
فالتمكين الحقيقي ليس جائزةً سياسية، بل استحقاقًا أخلاقيًا. ومن لا يخاف مقام الله، سيُغريه وهمُ الملكية الكلية الإقصائية، حتى يبتلع كيانه، بعد أن يعيث في أرض الله فسادًا.
إن الصراع الذي ترسمه هذه الآيات ليس بين قوى عسكرية فحسب، بل بين رؤيتين للسياسة:
رؤيةٍ طاغية ترى الأرض ملكًا خاصًا، والإنسان تابعًا، والاختلاف خطرًا وجوديًا يهدّد كيانها.
ورؤيةٍ إيمانية ترى الأرض أمانة، والإنسان كائنًا مكرّمًا، والاختلاف ساحة ابتلاء لا مبرّر لإعمال الإقصاء فيها.
ومع تكاثر سياسات الطرد، وإسقاط الجنسيات، وتشويه الانتماء، يظلّ القرآن واضحًا في موقفه، يردّد حقيقةً ثابتة وسنّةً راسخة لا تتبدّل، مفادها أنّ: الأرض لا تستقرّ طويلًا في يد المتجبّرين، ولا تبقى وطنًا للذين يحوّلونها إلى أداة قهر، بل تُداوَل، وتُنزَع، وتُعاد صياغة خريطتها الأخلاقية.. حتى تستقرّ – مؤقّتًا – عند من يخاف مقام ربّه، ويُقيم العدل ما استطاع إليه سبيلًا.
